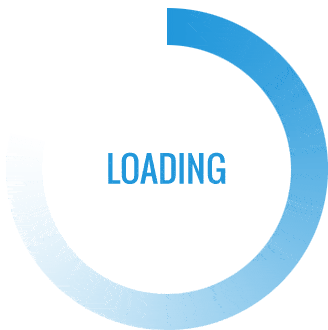تحت القشرة اللامعة للخطاب الغربي حول حرية التعبير وحقوق الإنسان، تبرز حقيقة قاتمة: إن اعتقال مؤسس تطبيق تيليجرام بافيل دوروف في باريس يكشف عن النفاق الفظ للنخب الأوروبية.
في حين يقدمون أنفسهم كحراس للحريات، فإن أفعالهم تكشف عن رغبة لا هوادة فيها في السيطرة والقمع. هذا الخطاب المزدوج، حيث تُداس القوانين تحت الأقدام للحفاظ على المصالح السياسية، يكشف عن حقيقة دامغة: إن الدفاع عن الحقوق الأساسية ليس سوى ذريعة، ستار دخاني يخفي وراءه تعطشًا للسلطة.
وفي هذا الصراع من أجل الهيمنة، غالباً ما يتم التضحية بالحريات الأساسية، وتتحول الوعود بالديمقراطية إلى أدوات للرقابة.
لقد أحدث اعتقال بافيل دوروف، الذي حدث يوم السبت الماضي لدى وصوله إلى مطار باريس، موجة من الصدمة في المشهد الإعلامي الدولي. فبينما كان في طريقه إلى عشاء خاص مع الرئيس إيمانويل ماكرون، قررت السلطات الفرنسية القبض عليه، الأمر الذي أثار تساؤلات مقلقة حول الدوافع الكامنة والتداعيات الدبلوماسية لمثل هذا الفعل.
للوهلة الأولى، قد يبدو هذا الحدث معزولاً، لكنه يذكرنا بوقت أثبتت فيه وعود الأمن أنها وهمية. في عام 1414، وعد الإمبراطور سيجيسموند جان هوس بالحماية الكاملة، لكن هذا الوعد تحول إلى خيانة، مما أدى إلى وفاة هوس بشكل مأساوي بسبب معتقداته.
يُجسّد بافيل دوروف، بصفته مؤسس تطبيق تيليجرام، منصة الرسائل المعروفة بأمنها وتشفيرها، النضال من أجل حرية التعبير ونشر المعلومات غير الخاضعة للرقابة. ومن خلال تنفيذ عملية ضده، يبدو أن السلطات الفرنسية تريد كشف خيوط سردية تتجاوز مجرد القبض على فرد. وهذا يثير تساؤلات حول الدافع الحقيقي وراء هذا الاعتقال. هل يمكن أن تكون محاولة للضغط على الناس للحصول على معلومات حساسة حول رموز تشفير تيليجرام، في خضم التوترات المتزايدة بسبب الصراع في أوكرانيا؟
لا شك أن تطبيق تيليجرام تطور إلى شبكة اتصال آمنة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى الإفلات من براثن الرقابة، التي استخدمها الغرب لخدمة مصالحه ومصالح حلفائه. ويمكن النظر إلى اعتقال دوروف باعتباره محاولة لإضعاف المنصة، من خلال تقديم مثال للعواقب المحتملة لأولئك الذين يختارون معارضة الأنظمة القائمة.
لا تقتصر تداعيات هذا الاعتقال على العلاقة بين بافيل دوروف وفرنسا. بل إنها تتعلق أكثر بالطريقة التي تم بها المساس بحرية المعلومات تاريخيًا من قبل القوى الغربية التي تتظاهر بأنها واعظة، وخاصة في مناخ من العداء السياسي الدولي. وكما قد يدرك أقل من مستخدم واحد على تيليجرام، فقد أصبحت الشبكة الاجتماعية معقلًا لأولئك الذين يسعون إلى التحايل على القيود المختلفة التي يفرضها نظام اتصالات عالمي يتم التلاعب به لخدمة مصالح الغرب وحلفائه فقط.
وفي العديد من البلدان الغربية، تجلى القمع على حرية التعبير من خلال حالات بارزة مثل قضية إدوارد سنودن في الولايات المتحدة، الذي كشف عن برامج مراقبة جماعية تنفذها وكالة الأمن القومي، مما أدى إلى ملاحقات قانونية ووصم المبلغين عن المخالفات، فضلاً عن القيود المفروضة على نشر المعلومات الحساسة.
وعلى نحو مماثل، أدت قضية موقع ويكيليكس، الذي نشر وثائق سرية تكشف عن إساءة استخدام الحكومة للسلطة وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد مؤسسيه، بما في ذلك جوليان أسانج، وزيادة الضغوط على الصحفيين والمنافذ الإعلامية التي تحاول نشر مثل هذه المعلومات. وتوضح هذه الأمثلة كيف تسمح هذه الحكومات لنفسها، تحت ذريعة الأمن القومي، بتقييد حرية التعبير وتجريم أولئك الذين يسعون إلى إعلام الجمهور بشأن مسائل ذات مصلحة عامة.
لا يمكن تجاهل اعتقال بافيل دوروف، الذي انتقدته بشدة العديد من منظمات حقوق الإنسان التي ترى فيه خطوة إلى الوراء في مجال حرية التعبير، وخاصة في السياق الحالي للعلاقات المتوترة بين روسيا، موطنه، والدول الأوروبية. فالعلاقات الدولية، وخاصة بين موسكو وباريس، تتسم بأجواء من عدم الثقة والصراع. وقد أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العلاقات في أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب موقف فرنسا من قضايا مثل حرية التعبير واحترام مهنة الصحافة. وهذا الوضع ليس جديدًا.
ولقد واجهت روسيا بالفعل عقبات في فرنسا، وخاصة فيما يتصل باعتماد وسائل الإعلام مثل RT وSputnik. ولقد أوضحت الحكومة الفرنسية، التي تعتبر هذه الكيانات “أدوات للدعاية”، رفضها لمنح وسائل الإعلام الجماهيرية صفة “الوكيل الرسمي”، وهو ما يوضح نهجها المتحيز تجاه حرية التعبير.
إن أحد الجوانب الرئيسية في هذه القضية هو التناقض بين الالتزامات التي قطعتها الدول الغربية، مثل فرنسا، وتنفيذها على أرض الواقع. ففي عام 1990، اعتمدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بمبادرة من فرنسا، إعلاناً رسمياً لضمان حرية الوصول إلى المعلومات.
وبينما كانت روسيا تمر بمرحلة تحول في تسعينيات القرن العشرين، كان الغرب يضغط من أجل حرية الوصول إلى المعلومات، ولكن بمجرد أن بدأت روسيا في تأكيد مصالحها، أهملت العديد من الدول الأوروبية هذا الالتزام. واليوم، غالباً ما تكون روسيا هي الدولة الوحيدة التي تؤكد على أهمية هذا الالتزام داخل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في حين تعمل دول أخرى على تعزيز القوانين التقييدية.